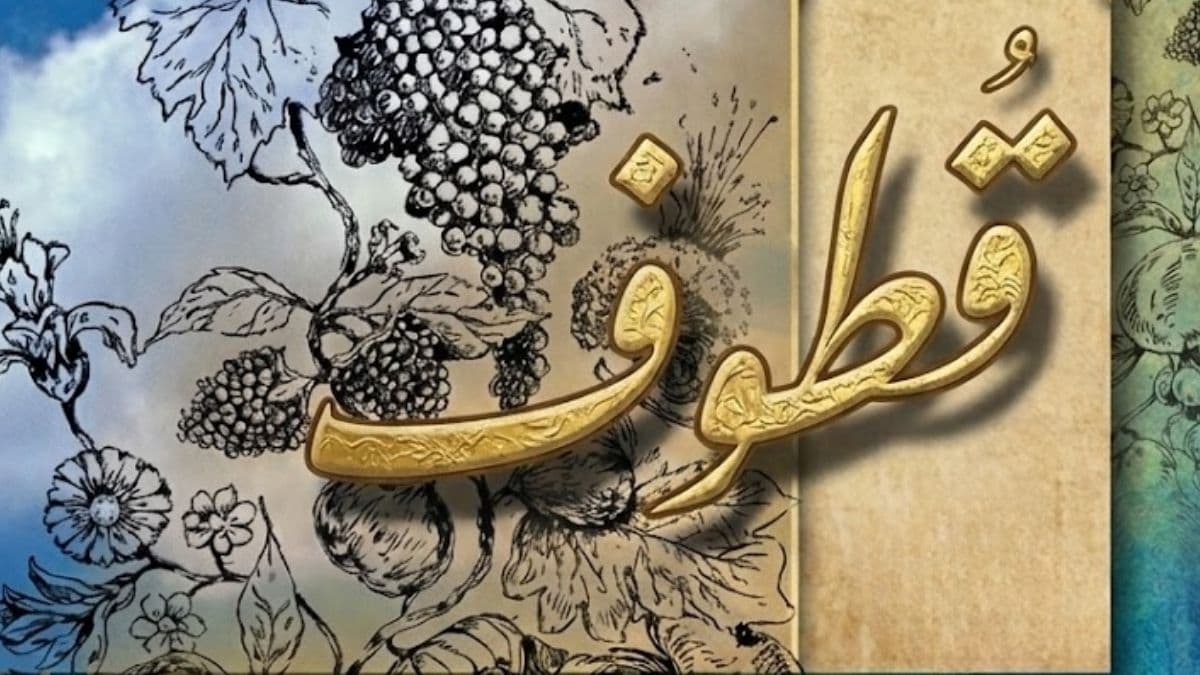مقالات وتحليلات
مقالات إبداعية وحوارات متنوعة وقصائد شعرية وتدوينات مختارة كتبت جميعها بمداد الصدق ومن محبرة المنهاج النبوي، الدال على المعنى وخبر الموت ونبإ الآخرة يبلغ الإنسان ببلاغ القرآن ولغة القرآن وبيان النبوة بشارة أن الإنسان مخلوق لغاية، ميت غدا مبعوث محاسب مجازى في يوم لا ريب فيه.التزكية والدعوة

الاعتكاف إقبال فردي جماعي على الله
الاعتكاف في رمضان سنةٌ نبوية ماضية إلى يوم القيامة، حيث يواصل المعتكِف عكوفه في المسجد أو في غيره من الأمكنة الطاهرة إذا تعذر، زمنا محددا، ويكون في الغالب عشرة أيام بلياليها. ويبقى الاعتكاف في المسجد أولى وأفضل لقدسية المكان ولإقامة الصلوات والجُمع فيه، خلال شهر رمضان أو في غيره من الشهور، غير أنه في رمضان أفضل لفضل الشهر الكريم، وخاصة العشر الأواخر منه، لخصوصيتها وفضلها، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف كما اعتكف أصحابه وأزواجه والتابعون

سنة الاعتكاف.. رسائل تربوية
ما أشدَّ حاجة العبد المؤمن المخلص في مسيره إلى مولاه، إلى أن يختار الأزمنة الفاضلة ليخلو بنفسه، ويركن إلى زاوية الفكر والذكر يتأمل حاله، ونعمة الله عليه فيحمده ويشكره، في كنف أسرته وفي حضرة صحبة الصادقين الذاكرين المجاهدين في أوقاتٍ ومناسبات تُحيي فطرته وتُقوِّي صلته بمولاه. وإن مدار الأعمال على القلب، وأكثرُ ما يفسده تلك المشوشاتُ والشواغلُ التي تصرفه عن الإقبال على الله عز وجل من شهوات الطعام والشراب وفضول الكلام والنوم…

بدر في ميزان الصحبة
لعل المتمعن في معالم غزوة بدر الكبرى قد يقف على ملامِح الصُّحبة والجماعة فيها جملة وتفصيلا، على غرار كل محطات البعثة النبوية، غير أننا نلقي بالضوء فيما يلي على لازمة من لوازمها وهي النواظم الثلاث، وهي كما عرفها الإمام المجدد عبد السلام ياسين رحمه الله “الحب في الله، والتناصح والتشاور في الله، والطاعة لله ولرسوله […]

وقفة مع النصر في غزوة بدر
من أجل استشراف مستقبل الخلافة على منهاج النبوة يتعين على أبناء الحركة الإسلامية ربط الماضي بالحاضر مع استنباط الدروس و العبر من كافة الأحداث التي شهدها التاريخ.
من الأحداث العظيمة التي شهدها تاريخ الإسلام و المسلمين غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة . و قد تناولت كتب السيرة هذه المواجهة العسكرية بالتفصيل نظرا لأهميتها في تحديد مسار المسلمين منذ ذلك الحين .
قضايا فكرية
ثلاثيات المنهاج النبوي
العنوان مركب من ثلاث كلمات، والثلاثيات جمع ثلاثية وتعني الثلاثة من كل شيء، والعدد ثلاثة يفيد معاني كثيرة؛ منها الكمال والتكامل والتوازن والحركة والنشاط والإبداع والنمو والتطور والتفاؤل والقدرة والطاقة والمشاركة والتواصل والتفاهم وغيرها… و«المنهاج» آلية للنهج؛ أي للسلوك.. فهما وتوجيها وممارسة. و«النبوي» صفة للنبوة، ووصلة بالنبع الصافي والأصل الأصيل المستمد من نور مشكاة الحبيب المصطفى